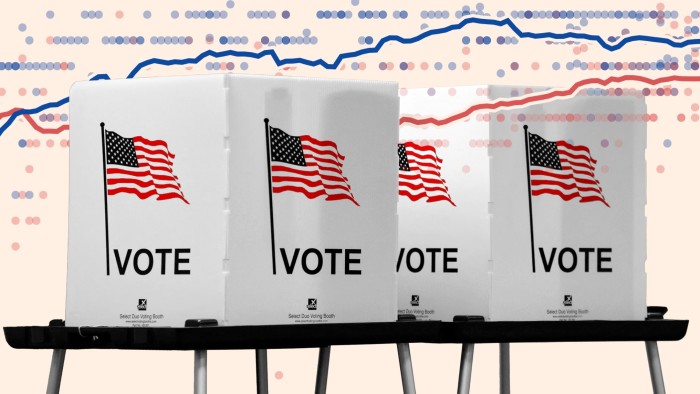افتح النشرة الإخبارية لـ White House Watch مجانًا
دليلك لما تعنيه الانتخابات الأمريكية لعام 2024 لواشنطن والعالم
كيف كان أداء استطلاعات الرأي في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي؟ قد يبدو هذا سؤالًا بسيطًا، ولكن اعتمادًا على ما تطرحه بالفعل، والمقياس الذي اخترته، وربما حتى معتقداتك الأساسية حول النفس البشرية، هناك ستة إجابات مشروعة بنفس القدر.
لنبدأ بالأساسيات. على المستوى الوطني، كان متوسط الاقتراع عشية الانتخابات هو فوز نائبة الرئيس كامالا هاريس بالتصويت الشعبي بحوالي نقطة ونصف. وفي وقت كتابة هذا التقرير، كان دونالد ترامب في طريقه للفوز بنفس الهامش، بعد أن أهدر مجموع نقاطه حوالي ثلاث نقاط. وهذا خطأ أصغر مما كان عليه قبل أربع سنوات، ويكاد يكون بمثابة تأثير كبير على المتوسط على المدى الطويل.
على مستوى الولايات، كانت استطلاعات الرأي في المتوسط أقرب إلى النتيجة هذا العام مما كانت عليه في عامي 2016 أو 2020. ومع ذلك، وللمرة الأولى منذ 50 عامًا من الاستطلاعات العامة، قلل متوسط الاستطلاع في كل ولاية من تقدير نفس المرشح – ترامب.
لكن الأمر هو أن هذه الإحصائيات نفسها تثير ردود فعل مختلفة تمامًا لدى الأشخاص المختلفين. بالنسبة للأمريكي العادي ذي الميول اليسارية الذي قضى أسابيع وهو يحدق في رقم أزرق أعلى قليلاً من الرقم الأحمر، كانت نتائج يوم الثلاثاء دليلاً صادماً على فشل استطلاعات الرأي. ربما كانت إهدار النقاط الثلاث 20 نقطة.
ولكن من وجهة نظر منظمي استطلاعات الرأي وعلماء السياسة والإحصائيين، كان أداء استطلاعات الرأي جيدًا نسبيًا. كانت الإخفاقات، على المستوى الوطني ومستوى الولايات، كلها ضمن هامش الخطأ، وتشير حقيقة أن استطلاعات الرأي لم تكن أسوأ في التقاط آراء ولايات ترامب من تلك التي كانت في الولايات المتحدة – وهو تناقض ملحوظ مع عامي 2016 و2020 – إلى لقد نجحت التحسينات المنهجية في السنوات الأخيرة.
إذا كان لديك إغراء الاستهزاء بهذه الفقرة الأخيرة، فاسمح لي أن أقدم لك هذا: بلغت عمليات البحث على Google في الولايات المتحدة عن مصطلحات مثل “لماذا كانت استطلاعات الرأي خاطئة” ذروتها أعلى بكثير في الأسبوع الماضي وفي عام 2016 مما كانت عليه في عام 2020، على الرغم من حقيقة أن قللت استطلاعات الرأي من تقدير ترامب بشكل أكبر في عام 2020.
والسبب واضح إلى حد ما، لكن لا علاقة له بالإحصائيات أو بمنهجية الاستطلاع. العقل البشري أكثر ارتياحًا للثنائيات من الاحتمالات، لذا فإن الإخفاق القريب الذي يقلب عالم المشاهد يكون مؤلمًا أكثر بكثير من الإخفاق الأوسع الذي لا يحدث ذلك.
لكنني لا أقصد أن أترك الصناعة خارج نطاق المسؤولية تمامًا، وتحقيقًا لهذه الغاية هناك قضيتان منفصلتان تحتاجان إلى المعالجة.
الأمر الأكثر وضوحًا هو أنه على الرغم من أن نتائج استطلاعات الرأي كانت أفضل قليلاً هذا العام، إلا أن هذا كان لا يزال الاستهانة الثالثة على التوالي بترامب. ومن الواضح أن التعديلات المنهجية التي أجرتها مؤسسات استطلاع الرأي منذ عام 2016 ساعدت بشكل واضح، لكن المشكلة الأساسية لا تزال قائمة. سواء كان ذلك بسبب مصادر التحيز الجديدة التي قدمتها هذه التعديلات، أو إلى مزيد من التحولات في المعدلات التي تجيب بها أنواع مختلفة من الأشخاص على الاستطلاعات، يبدو أن منظمي الاستطلاعات يسيرون على السلم المتحرك لأعلى.
أما المشكلة الثانية فهي مسألة أكثر جوهرية تتعلق بكيفية عرض الأرقام. صحيح أن منظمي استطلاعات الرأي ومجمعي استطلاعات الرأي ظلوا يصدرون تحذيرات عالية وواضحة لأسابيع حول كيف أن الهامش الضيق للغاية في استطلاعات الرأي لا يمكن أن يؤدي فحسب، بل من المحتمل جدًا، أن يؤدي إلى فوز جانب أو آخر بشكل حاسم. لكن مثل هذا الانتشار للتحذيرات الصحية يثير التساؤل حول ما إذا كانت استطلاعات الرأي ومتوسطات الاقتراع وتغطيتها في وسائل الإعلام تضر أكثر مما تنفع.
لنفترض أنك منظم الاستطلاع وأنا الصحفي نعلم أن هامش الخطأ الحقيقي في الاستطلاع هو في أفضل الأحوال زائد أو ناقص ثلاث نقاط لكل مرشح – أي أن الاستطلاع الذي يتقدم فيه المرشح “أ” بنقطتين لا يتعارض مع ذلك يخسر المرشح بأربعة في يوم الانتخابات حتى لو كان الاستطلاع مثاليًا. ولنفترض أننا نعلم أيضًا أن البشر يكرهون عدم اليقين بشكل غريزي وسيركزون اهتمامهم على أي معلومات محددة. إذن من الذي يخدم عندما نسلط الضوء على رقم واحد فقط؟
إذا أردنا التقليل من مخاطر الصدمات السيئة التي قد تتعرض لها شرائح كبيرة من المجتمع، وأردنا أن تحصل مؤسسات استطلاع الرأي على جلسة استماع عادلة عندما تظهر النتائج، فيتعين على الجانبين أن يتقبلا حقيقة مفادها أن استطلاعات الرأي تتعامل في نطاقات غامضة، وليس أرقامًا ثابتة.