رحلة الأديب العربي السوري الكبير نبيل سليمان (مواليد صافيتا في محافظة طرطوس، 1945) رحلة شاقّة في عالم الكتابة والثقافة، ولكنها تنبئ -حين نراجع بعض معالمها- عن جبلّته وعزيمته المتينة التي قطعت كل هذه السنين دون أن تهِن أو تتراجع أو تضعف، بالرغم من كثرة التحولات والمتحوّلين، فلقد عرف منذ كتب روايته الأولى “وينداح الطوفان” (1970) -وربما قبلها- أن المثقف الحقيقي هو المثقف النقدي المستقل، ولذلك احتفظ بمسافة كافية من السلطة وأجهزتها وأعوانها، مسافة كافية للمراقبة والنقد والصوت المستقل.
ولم يكتفِ بكتابته السردية وموهبته الروائية، بالرغم من ثرائها واتساع مدوّنتها ونضج أساليبها، فكتب في النقد الأدبي والشؤون الثقافية والقضايا الفكرية والسياسية والتربوية التي تعني الكاتب والقارئ، وتشغل المواطن السوري والعربي، مما كرّس صورته في هيئة مثقف مسؤول أو ملتزم بطريقته ومنهجيته الخاصة التي لا تتبع سلطة ولا حزبا، وإنما تنبع من استقلال المثقف ومن حقّه الجوهري في النقد والتعبير، وفي قراءة توجّهات مجتمعه والتأشير على ما لا يعجبه من ظواهر وسياسات على مستوى المجتمع وسلطاته المختلفة.
وهذا ما ينبئ به سجل نبيل سليمان الكتابيّ المتنوع الحافل بالنقد والمسؤولية والالتزام، وقد نشر منذ عام 1970 حتى اليوم: 23 رواية، و38 كتابا في النقد الأدبي والفكر والشأن الثقافي، وجذبت أعماله الأدبية والنقدية اهتمام الباحثين والنقاد والقراء، فكُتبت عنها عشرات الدراسات والمؤلّفات والبحوث والأطروحات الجامعية في مختلف أنحاء العالم العربي. يضاف إلى رصيده السابق مواقفه الشجاعة التي لم تخلُ من عواقب قاسية في بعض الأحيان، تضمّنت الاعتداء المادي أو الجسدي عليه، وتهديده وترويعه في وقائع معروفة ومثبتة.
ولا ننسى دور سليمان في حركة النشر العربي من خلال (دار الحوار) التي أسسها عام 1982 في اللاذقية، وقامت هذه الدار بدور واسع طوال عقود في رفع سوية الكتاب العربي وتشجيع ترجمة الكتب الثقافية والفكرية المهمة التي تنقص المكتبة العربية، وقد كان نشاطها يحتكم إلى وعي مؤسسها واتساع علاقاته مع الأدباء والمؤلفين، مما مكّن الدار من نشر آلاف الكتب النوعية التي لا تزال تواصل ذلك الدور التنويري وهي تتنقل بين أرفف المكتبات وأيدي القراء في مشارق الأرض ومغاربها.
الرواية في مواجهة السلطات الغاشمة
نتوقّف في هذه الإطلالة عند واحدة من روايات سليمان الأخيرة وهي الرواية الـ22 في سجل إنتاجه الروائي، وعنوانها “تاريخ العيون المطفأة” المنشورة عام 2019 في طبعة مشتركة بين دار مسكلياني/تونس، وميم للنشر/الجزائر. ومن يعرف بعض علامات مسيرته في أكثر من نصف قرن من الكتابة والاجتهاد السردي والنقدي فسيتوقّف أولا عند هذه الروح المقدامة فنا وتجريبا ومعنى، لأن سليمان لا يستريح عند مرحلة أسلوبية أو رؤيوية عرفها أو أتقنها وإنما يبدو لقارئه كما لو أنه يبدأ من جديد حريصا على الإصغاء لنبض المرحلة الجديدة ولما تأتي به من أفكار وأساليب وما تقتضيه من تحدّيات، ولذلك حافظت تجربته على جدّتها وحيويتها على امتداد العقود والسنين.
وإذا كانت مواجهة السلطات الغاشمة والظالمة بصورها السياسية والاجتماعية والدينية قد وجدت تمثيلاتها في تاريخ الكتابة عند سليمان، كما في روايات: (السجن) و(سمر الليالي) و(ليل العالم) و(دلعون) على سبيل المثال، وكما في (مدارات الشرق) عبر تمثيلات التاريخ في رواية ملحمية رباعية (4 أجزاء) فإن رواية (تاريخ العيون المطفأة) تعدّ خطوة أخطر وأبعد في هذا المضمار من المواجهة والمجابهة، لأنها لم تكتفِ بسردية مفردة أو تجربة واحدة، وإنما واجهت سيلا من السلطات الفاسدة والقوى التي قادت مجتمعها إلى الخراب وفقد البصر والبصيرة، فالرواية في مثل هذا الحال سبيل مقاومة وسبيل كشف ونقد للقوى المستبدّة في بلاد يعرفها القاصي والداني.
من المؤكّد أن هذه الرواية انطلقت من الواقع الذي عاشته سوريا في السنين الأخيرة، خصوصا العقد الدامي منذ عام 2011 وحتى زمن كتابة الرواية، واجتهدت في توصيف واقع الحال وفي كشف الأسباب والمقدّمات والسلوكات والسياسات التي أدّت إلى أن تصل الأمور إلى خراب وعماء لا رجعة عنه.
استعمل الراحل عبد الرحمن منيف تسمية “شرق المتوسط” فرارا من تسمية الجغرافيا المقصودة أو تحديد قطر عربي بعينه، أو تعميما للدلالة لأن ما يعبر عنه يخص معظم أقطار منطقتنا إذ تتفق جميعا على التسلط والاستبداد. وعلى نحو مقارب فعل نبيل سليمان عندما اخترع تسميات لأقطار أو بلدان أو مدن ثلاث وهمية لا وجود لها بالمعنى المباشر، ولكنها تشبه ما يعرفه القارئ من مدن وأقطار هنا وهناك في المنطقة العربية، وفي مقدّمتها بلد المؤلف نفسه، الذي ربما انطلق منه دون أن ينغلق عليه أو تقف دلالته عنده فحسب.
ومعنى هذا أن البلدان الثلاثة المتجاورة (بر شمس، قمورين، كمبا) ليست إلا رموزا لجغرافيا الاستبداد والقمع والتسلط، وحين ذاك لا يهم اسمها أو تحديدها وإنما المهم تمكين الرواية من نقدها وتعريتها والكشف عن فقرها للحريات ومعاداتها لحقوق الإنسان، بل محاربتها للإنسان في عمله وطعامه وشرابه، وكأنها تتبع (إستراتيجية) تؤدّي في نهاية الأمر إلى (حيونة الإنسان) إذا شئنا استعارة العنوان المعروف لأحد كتب الراحل ممدوح عدوان.
عتبة العنوان ودلالة العمى
استنادا إلى عتبة العنوان (تاريخ العيون المطفأة) نتلمّس طريقنا إلى قراءة بعض معالم هذه الرواية المهمة في تمثيل واقع التأخر والتخلّف والنكوص عن النهضة والتقدّم، انطلاقا من كناية العمى وضعف النظر للدلالة على ضروب من العمى الحضاري، لأن العمى ليس واقعة جلبتها المصادفة، ولا وباء قدريا، وإنما هو كناية كبرى تتلاءم مع النثر الروائي في اشتباكه مع واقعه الفعلي-الحقيقي، فكيف يمكن تجسيد هذا الخراب الذي يتسلل إلى كل المفاصل، ويضرب بجذوره في كل الأنحاء، بل كيف يمكن التعبير عنه في ظل أنظمة وحشية قمعية، لا تحتمل التسمية.. لم توارب الرواية كثيرا ولم تبالغ في تصويرها فالوقائع العجيبة المضمنة فيها مما عاشه العميان وضعيفو البصر ما هي إلا بعض وقائع عصرنا وواقعنا العربي الراهن.
ولعل استعمال لفظة (تاريخ) في العنوان يفيد أن للأمر مقدّمات وأنه ليس مفاجئا أو قدريا، إنه عمى مصطنع، أو بفعل فاعل، ولذلك فالعيون مطفأة، بصيغة اسم المفعول، ومن مهمات الرواية أن تشرع في تشريح ملابسات إطفائها وسمْلها، وتحويل المجتمع كله إلى مجتمع عميان بلا بصر أو بصيرة.
ولتقريب هذه الرواية من القارئ يمكن الإشارة إلى أنها اختارت ضربا مؤثّرا من التمثيل عبر استعارة فكرة العمى (العيون المطفأة) تلك الاستعارة المخيفة التي يمكن تحميلها وجوها مختلفة من الدلالة والمعنى، “وتلك هي متعة التمثيل السردي في هذه الرواية وسرّ قوّتها الضاربة” كما كتب سعيد بنكراد في كلمة الغلاف الأخير.
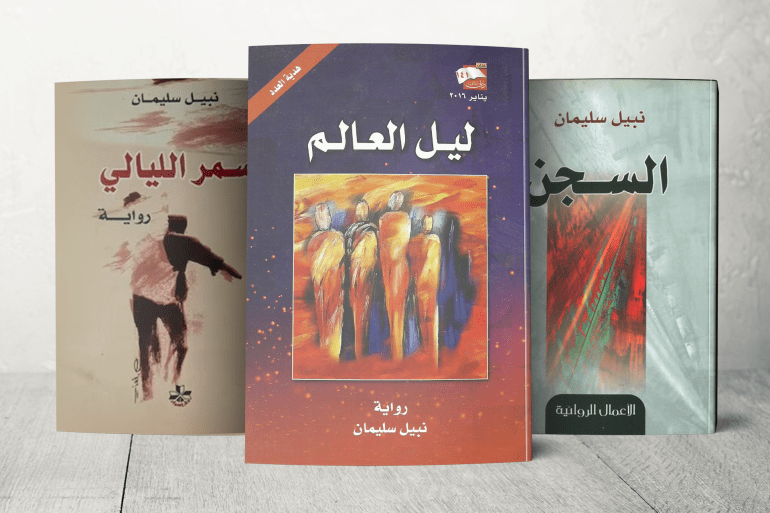
كما اختار المؤلف أسلوبا مشتقّا من “الواقعية السحرية” التي خبرها في روايات سابقة، بما فيها من إمكانات مفتوحة لالتقاط غرائبية الواقع ومعانقة عجائبيته، بلغة يختلط فيها السرد بالشعر والواقع بالخيال. وفي متن الرواية كثير من الإشارات التي تعضد المعنى السابق، من ذلك ما جاء على لسان شخصية (آسيا) في حوارها الهاتفي مع (مولود) وهي تشرح ما تودّ الكتابة عنه:
“المهم الآن هو هذا الوباء الذي يكاد يصيبنا كلنا. لا أقصد فقط وباء ضعف البصر الذي تحوّل إلى عمى. أقصد أيضا هذا الخراب. هذه الوحشية والكل فيها سواء تقريبا. هذا الوباء أدهى وأمرّ من وباء العمى وضعف البصر. أحيانا أفكر أنهما وباء واحد له أكثر من شكل”
(ص234)
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر فإن (تاريخ العيون المطفأة) تستدعي في ذاكرتها وبنائها ولغتها أعمالا أدبية وشخصيات ومكوّنات ثقافية سابقة ذات صلة بالعمى وباستعارة فكرة الوباء الشامل تعبيرا عن فساد الواقع واختلاله، وفي مقدّمة تلك المكوّنات رواية (العمى) للكاتب البرتغالي (خوزيه ساراماغو) وتقيم مع هذه الرواية ضربا من الحوار والجدل، ربما استباقا لما يمكن أن يقوم به القارئ من مقارنة، بحثا عن نقاط الالتقاء والافتراق.
نعثر على هذه المواجهة بين العملين بوضوح في أحد فصول الرواية، في حوار متخيل بين شخصية آسيا (المثقفة والروائية) وسدير المحامي والفنان (الكفيف) الذي يمثل نموذجا للأعمى المبصر، تتمنع الرواية المفترضة التي تكتبها آسيا فتشكو أمرها إلى سدير، وفي سياق الحوار تقرّ آسيا أنها قرأت رواية العمى وأعجبت بها، لكنها تنتقد نهايتها “لكن نهايتها مثل نهاية فيلم ميلودراما تزول فيها العتمة ويعود البصر إلى من عمي” (ص306).
وينبّهها (سدير) إلى بعض الدلالات المهمة في رواية (ساراماغو): “هل تذكرين كيف جعل اعتقال العقل هو العمى؟ كيف جعل اليأس هو العمى؟ العراك هو العمى..” (ص307). ولا شك في أن الدلالة الكبرى الحضارية للعمى ومبدأ اختبار السلوك الإنساني في وقت الأزمة هي من النقاط المشتركة بين الروايتين وربما سائر الأعمال والروايات المعروفة عن الأوبئة مما ذكرته رواية سليمان ومما لم تذكره.
وفي سياق الفصل والحوار المشار إليه تنكشف بوضوح دلالة العمى والعيون المطفأة المرادة، في جواب (سدير) عن سؤال آسيا: ما العمى؟ فيكون الجواب: “العمى كثير.. نظام التعليم عندنا من رياض الأطفال فصاعدا هو عمى، عمى يولد عمى. هذه الفضائيات والإذاعات، هذا الإعلام في بر شمس، بل في العالم كله ليس غير عمى يولد عمى..” (ص307).
وأما نقيض ذلك أو خارطة الطريق للمستقبل ولواقع مبصر، فيتمثل بعضه في جواب (سدير) أو تعريفه للبصر: “لنقل مثلا: البصر هو المظاهرات السلمية التي قامت بالأمس القريب، ليس في بر شمس وحدها بل في كمبا في قمورين، لنقل: البصر هو الشباب الذين خرجوا في تلك المظاهرات ونظموها وقادوها. والعمى بالتالي هو من أجهضوها بأي وسيلة كانت، بالقمع بركوب الموجة من أجل كراسي الحكم، إلى آخره. هل أضيف: البصر هو الحرية؟ البصر هو العلم والمعرفة؟ البصر كثير كما أن العمى كثير”. (ص309).
فهذه الفقرات الحوارية مهمة في الكشف عن المعنى المتواري والموارب للرواية من جهة، وفي بيان صلة رواية سليمان بالروايات العالمية السابقة التي اتخذت من كناية العمى مفتاحا مكونا لها وسبيلا لتجسيد عالمها، وفي مقدمتها رواية العمى لساراماغو أقرب تلك الأعمال إلى تاريخ العيون المطفأة مع جهد الأخيرة في تطوير الكناية لتتلاءم مع مكونات الواقع العربي الذي تعالجه.

أنماط الراوي وأساليب السرد
نلتفت إلى التشكيل السردي المتنوع والرحب الذي اتسمت به الرواية، فالبناء الإطاري أو أسلوب الحكاية الإطارية الذي نظّم فيه سليمان روايته، وهو بناء عربي صميم من أبنية الحكاية العربية، نجده في ألف ليلة وليلة وفي قصص المقامات وفي كثير من النماذج العربية التراثية، ويقوم هذا البناء على تأطير الحكاية بمقدمة تمثل إطارا افتتاحيا وبخاتمة تغلق مكونات الحكاية تمثل إطارا ختاميا، وبين الإطارين يتوزع متن المادة بتنظيم خاص يمثل ضربا من الإشباع والتفصيل لما سمح الإطار الافتتاحي به أو استدعاه.
وإذا نظر القارئ إلى فهرست الرواية فسيلاحظ هذا البناء الإطاري المحكم، المكوّن من فصل افتتاحي عنوانه (كالمقدمات)، ثم متن الرواية وفيه 48 فصلا يتخذ كل عنوان تسمية (العين الأولى، العين الثانية…) وصولا إلى (العين الثامنة والأربعون) مع عنوان شارح إلى جانب هذا العنوان الترتيبي. ولعل عدد العيون (الفصول) يوافق عام 48 من القرن الماضي، وهو عام النكبة الذي ألمحت إليه الرواية غير مرة، عندما أشارت إلى مشاركة جيل الآباء في حرب فلسطين وأنهم هزموا مع بقية العرب، ومنذ ذلك العام والأحوال تتراجع ولا تتقدم، فكأن تلك الإشارة التاريخية هي بداية العمى والهزيمة، فاختارها المؤلف تأطيرا أو تحديدا لعدد فصوله.
وتختم الرواية بإطار ختامي من مهمته إقفال الرواية وإنهاء وظيفة الإطار معنون بـ (كالخواتيم) ويتميز هذا الإطار باعتماده على الفراغ والسطور التي تتكوّن من نقاط تدل فيما تدل على ما لم يكتب أو المحذوف الذي تدعو القارئ إلى إتمامه، إنه ضرب من النهاية المفتوحة لجراح لم تبرأ. فيغدو الفراغ أبلغ وأكثر تأثيرا في دلالته المفتوحة التي تستدعي المشاركة في وضع النهاية. أما هذه الكاف في (كالمقدمات، كالمتون، كالخواتيم) فهي أداة التشبيه التي تتلاءم مع الطبيعة التخييلية للرواية ومادتها، إنها لا تغير وظيفة الإطار ولا متنه، ولكنها تقلل الثقة فيه بتخفيف دعوى حقيقته وواقعيته لصالح مداه التخييلي والتمثيلي.
ومن ناحية أنماط الراوي فإن الرواية تنفتح في إطارها الافتتاحي على راو شعبي، يفتتح سرده بعبارة معدّلة لعبارة افتتاحية قديمة: “كان لا ما كان، وغير الله ما كان. كان في حاضر العصر والأوان بلاد حباها الله من نعمه، وأنعمت عليها الطبيعة من آلائها…” (ص7)، وسوف تتردد أصداء العبارة الافتتاحية في مواضع مختلفة من الرواية لها دلالتها، ولكن يكفي هنا الإشارة إلى دورها الصياني للحكاية بتركيز سردها، ومنع تشتتها خصوصا عندما يتشعب السرد داخل فصول الرواية وتتعدد مواقفها وشخصياتها ويذهب بها الصراع والتنقل كل مذهب.
ويحضر الراوي الشعبي من جديد في فصول مختلفة من الرواية، كما هو الحال عندما يتراءى في هيئة شخصية (الحكواتي)، وهناك ثلاث شخصيات تُقدم في البلدان الثلاثة (كمبا، بر شمس، قمورين) تنتمي إلى هذه الصفة أو الوظيفة، تتولى تقديم سردها بأسلوب يدمج السرد الحديث بخصائص سرد الحكواتي مما يفعّل دوره ويضفي على الرواية مزيدا من خصائص السرد التراثي والشعبي.

تنويعات الراوي
لا تعني إشارتنا إلى هذا الراوي الشعبي الذي يفتتح الرواية ويتراءى فيها مرارا أنه الراوي المسيطر أو الحاضر دوما، ولذلك فإنه ليس إلا واحدا من أنماط الرواة الحاضرين، ولن تبقى الرواية -نظرا لطبيعتها ورؤيتها- ضمن أسْر النمط الشعبي أو العمومي وإنما ستخرج عليه، ويتسع المجال في فصول المتن لحضور الراوي العليم الذي يعرف عن الشخصيات كل شيء، بل يتمكّن من العبور إلى داخلها وتحليلها والحكم عليها، وهو في مقدرته المتفوّقة والتحليلية قريب الشبه من إمكانات راوي (العمى) لساراماغو، فهو يسير على خطاه في عدم الاكتفاء بالدور السردي وإنما يتجاوزه إلى التأمل والتحليل والمراجعة والنقد، إنه راو متمكن داخلي وخارجي في آن، وهو لا يخشى الظهور والانكشاف ولا يخشى أن يسأله أحد: كيف عرفت أو ما أدراك؟ خصوصا مع إمكانات الواقعية السحرية التي تتردد بين الواقعي والمتخيل، وبين تمثيل الحقيقي والتاريخي وتمثيل الأحلام والكوابيس دون فواصل أو تنبيهات لهذا التردد.
ويستريح هذا الراوي العليم في كثير من المواقف والفصول، فيختفي أو يتراجع ليسمح لأنماط أخرى بالظهور، في مقدمتها الراوي بضمير المخاطب (السرد بضمير أنت)، وأغلب مواقف ظهور (أنت) تلك المواقف التي تواجه فيها الشخصية نفسها.
أي إن الخطاب يتوجه إلى الذات وليس إلى الآخر، تستخدم صيغة المخاطب للتعبير عن الوجه الآخر للشخصية، مما يعني تمزّقها أو انقسامها إلى شخصيتين، كأنها أمام مرآة، فتتسع المساحة للمحاسبة وللمراجعة، ولعقاب الذات أو لومها، فضلا عما يسمح به هذا النمط من التهيؤ للخطوة التالية وهو غالبا ما تفضي إليه هذه المواجهات أو التسويات. ولعل من الأمثلة البارزة لحضور ضمير (أنت) تلك المواقف التي تواجهها شخصية (مولود) بصفة خاصة، لما تتعرّض له من تحولات ومن أزمات تتطلب أن يقف أمام نفسه وأن يحاول تسوية أمره واستعادة رباطة جأشه بين أزمة وأخرى.
وهناك فصول ومواقف تتولى السرد فيها الشخصيات نفسها، فيغدو السرد داخليا بضمير المتكلم، بما يسمح بتلخيص تجربة الشخصية أو حكايتها أو ما تسمح به منها، من أمثلة ذلك سرد نجم الدين الصمدي (أبو وعد ووالد مليكة) عندما حدّث مولود بقصته ورحلته إلى اليمن بحثا عن أصل عائلته، فغدا في هذه المواقف راويا متكلما يقدم تجربته وحكايته ويرويها للآخر بضمير المتكلم، إنه ضرب من تلخيص الحكاية، من جهة، وضرب من حديث المسامرة من جهة أخرى مما يبقي على خيط التواصل قائما، دون أن يتحول السرد بضمير المتكلم إلى ضروب المناجاة والمونولوغ والشفافية الداخلية، بل تبقى المساحات النفسية الشفافة من وظيفة السرد بضمير المخاطب.
وفي هذا النسيج المركّب من الرواة ثمة مساحات حوارية، يغدو دور الراوي فيها دورا ضمنيا يتمثل في نقل الحوار وبيان هيئة المتحاورين وسيماهم، ولكن حضور أطراف الحوار، وكلام الشخصيات أكثر من دور الراوي.
إذن بالرغم من حضور الراوي العليم فإن الرواية لم تخضع له خضوعا تاما، وإنما نوّعت في أنماط الرواة، مما نوع أساليب السرد، وأسهم في تعدد مواطن التبئير وما يتبعها من تنويعات وأساليب، وأضفى هذا التنوع جانبا من المتعة السردية التي تخفف من غلواء القتامة في رواية تقصدت التحرش بهذه المساحات السوداء المتشققة من عالمنا الراهن.
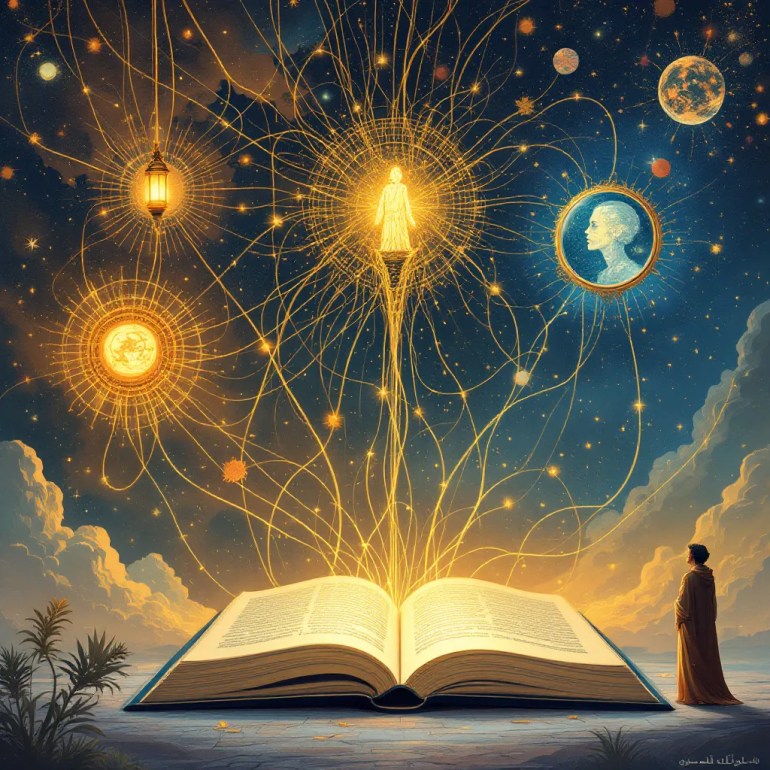
لمسات من السرد البوليسي وسرد المغامرات
ربما كانت شخصية (مولود) أكثر الشخصيات ظهورا على امتداد الرواية، والخيط الناظم بين شخصياتها، وربما كان هذا الخيار هو الأفضل لأنها الشخصية الأكثر اعتدالا أو توسطا بين الشخصيات، فهو لم ينتم إلى المعارضة ولا إلى السلطة انتماء تاما، قريب من هؤلاء وهؤلاء، يفيد من كل طرف بمقدار ما يلزمه، إلى جانب أنه ليس شخصية مكتملة ولا ناضجة تمام النضج، ولذلك بدا مرشحا للتغير والتطور، خلافا لشخصيات أخرى ظهرت مكتملة وبخيارات محسومة سلفا، وهذا جعله مرشحا أكثر من غيره للاستمرار وملاحظة آثار الضغوط والتجارب التي يعيشها أو يواجهها مع كل أطراف النزاع.
وإذا كان قد انتقل أولا انتقالا اختياريا من بلده (كمبا) إلى البلد المجاور (بر شمس) مدفوعا بهاجس اللحاق بحبيبته وقريبته (أماني) التي هاجرت مع أسرتها وهناك قرر إتمام دراسته، والابتعاد عن أسرته التي يشعر بالكراهية إزاءها، كل ذلك سمح لتجربة (بر شمس) أن تصقله وتنضج شخصيته، تعرف فيها إلى الشخصيات التي سيتمم معها حياته ومراحله الأخرى، ارتفعت محبته لأماني ولأسرتها التي احتضنته حتى وقفت عند إصابة الفتاة بضعف البصر وبما ينبئ بفقدانها له مستقبلا، وصولا إلى الجملة التي لم يجب عليها (هل تتزوجني إذا عميت)؟ يتزامن هذا السؤال مع طلبه المتكرر لدوائر التحقيق بسبب صداقاته وعلاقاته مع شخصيات قيد المراقبة ولها نشاطات مناوئة للسلطات، ويتطور ذلك إلى إبعاده أو طرده، فيختار (قمورين) بلد مليكة التي تعرف إليها أثناء دراستها والتقى بها في إحدى زياراتها لبر شمس، وشعر أنها بداية خيط بديل لخيط أماني.
وفعلا ينتقل إلى بلدها (قمورين) وتكون دليله وسبيله للاستيطان، فيتعرف إلى والدها وإلى أصدقائها، يعمل ويسكن ويعيش بمشورتها ومساعدتها. ولكنه كما رسمته الرواية دائما يفيد من الآخرين ويتجاوزهم. يفشل في تجربة الحب الاختيارية والراضية بينهما، في أول لقاء يجمعهما في غرفته الصغيرة، ولكنه لاحقا سينتقم ضمنيا باغتصاب هذه الفتاة التي أحبته وساندته، ولكنه انقلب عليها وتاجر بها بعد تغير شخصيته إلى الأسوأ.
لقد وقع في (قمورين) تحت تأثير المحقق أو اللواء مشرق، فتدرج في قبول العمل معه، ويغدو من مهماته التجسس على آسيا صديقته القديمة ابنة الكولونيل في بر شمس، وعلى مليكة وأسرتها، وعلى أخيه عبد المهيمن الذي نفاجأ بأنه تاجر سلاح استفاد من الحروب والصراعات الدائرة وله علاقات وثيقة مع المسلحين الذين حملوا السلاح ضد السلطة، ولم يكتفوا بالمظاهرات والمعارضات السلمية.
المهم أننا في هذا الجزء من الرواية إزاء سرد بوليسي مشوق لأنه يقتضي السير في خطة وضعها البوليس للتفاهم مع عبد المهيمن بتوظيف أخيه وإرساله وراءه إلى اليونان، يقوم مولود بهذا الدور ويسافر إلى أثينا وينجز اتفاقا مع أخيه لصالح السلطة، ولكنه خلال ذلك يستفيد هو من ثروة أخيه ويقتسم جزءا منها مع اللواء مشرق، ليسكته ويشتري مساعدته، كأنما غدا مولود جزءا من الخراب الدائر، بما فيه بيعه لبيت مليكة، وعند عودتها يغتصبها بدلا من أن يحبها ويقنعها بحبه.
الاغتصاب ينجح فيه ولا ينجح في الحب، ربما إشارة إلى الواقع الممزق الذي تعيشه الشخصيات مما لم يسمح بنجاح أي علاقة حب لمولود أو لغيره. ومع محاولته استعمال ذكائه ونجاحه النسبي فيه وحصوله على الثروة فقد انتهى إلى الاختفاء والقتل، واتهم أخواه (معاوية، وعبد المهيمن) السلطات في قمورين بقتله (خصوصا شريكه ومشغّله اللواء مشرق).
أما شقيقه معاوية ضابط المخابرات في (كمبا) فقد اخترع وسيلة جديدة تتمثل في فقْء عيون المرضى والمعتقلين والضعفاء، والاتجار بها عبر مستشفيات وبنوك للعيون أسسها لهذه الغاية، ويشير هذا التفصيل إلى استثمار السلطة القمعية كل الوسائل بما فيها سلطة العلم، وحرفِها عن غاياتها لصالح غايات السلطة ورجالها وسعيها للمال بكل وسيلة.
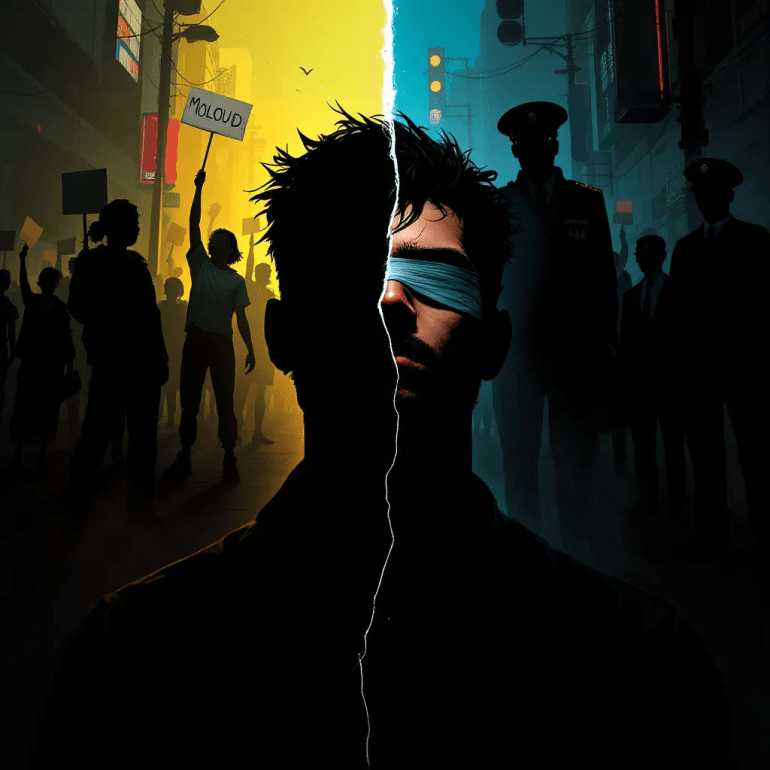
أنماط الميتاسرد
في الرواية شخصية نسوية مهمة، سبقت الإشارة إليها هي التي تحمل اسم (آسيا) ابنة كولونيل موال للسلطة وجزء منها، لكن آسيا على خلاف وتضاد معه، ومع أهمية هذا التضاد الذي يظهر عمق المأساة وتداخل الأضداد في مجتمع الرواية، فإن لها وظيفة أخرى غاية في الأهمية فهي -كما قدمتها الروائية- مثقفة ومشروع روائية تحاول أن تكتب روايتها استنادا إلى الشخصيات التي تعرفها وتتواصل معها.
تلك الشخصيات التي تمثل المجتمع بأطيافه ومواقفه المختلفة، مهمة آسيا وروايتها المفترضة وظّفتها رواية سليمان في إضفاء طابع الميتاسرد الذي مكّن المؤلف من مناقشة شخصيات الرواية، ومناقشة موقف الرواية من عالمها وتقنياتها، إلى جانب استرجاع روايات العمى وطرف من المكونات الفنية والشخصيات العربية والعالمية المرتبطة به، بما يظهر جانبا من ثقافة الرواية المكتوبة في هذا المجال، وعمّق نظرتها واستعدادها إلى موضوعها وثيمتها.
كما مكّن هذا الميتاسرد من بناء حوارات مهمة عن رواية العمى لساراماغو أقرب الروايات العالمية التي حاولت رواية نبيل سليمان إقرار اتصالها بها وإعلان انفصالها واختلافها عنها مما أوضحناه في فقرة سابقة. وإذا كانت آسيا قد انشقت عن والدها وأسرتها واختلفت معهم، فإن الرواية تنسب ذلك ضمنيا إلى نسبها الفكري ووعيها السياسي الذي جعلها تربط بين الثقافة والفلسفة والسياسة، فتنتمي إلى عالم أصدقائها المعارضين، خصوصا سدير الفنان الكفيف وما أضافه إلى عالمها وإلى وعيها، فلم يعد يربطها بوالدها رابط سوى رابط الدم الجبري.
الكرنفالية: أطراف من بهجة العمى
تتناول الرواية عالما شديد التجهم والكآبة، فيه قتل وعنف وسجن وترويع، وعمى وفقء للعيون، وفيه زعماء فاسدون ومحقّقون أجلاف، وتجار أسلحة، وذباحون للبشر إلى نهاية ألوان التعذيب والترويع. وبالرغم من وجود هذا العالم المرعب وربما بسبب وجوده، فإن الرواية لم تنغلق على وصف هذا العالم وحده، فالحياة والموت يتداخلان، والعمى والبصر والبصيرة تتبادل الأدوار، ولكي يتوازن عالم الرواية وهي تومئ إلى الخروج من راهنها الكئيب إلى مستقبل أفضل فلا بد من نوافذ مضيئة ذات طابع أقرب إلى الحياة، وإلى ضروب من الكرنفالية والاحتفالية المبهجة وسط هذا الدمار.
في هذا السياق نقرأ تلك المشاهد الأقرب إلى استراحات أو وعود أو خيوط للحياة بالرغم من كل ما يحاصرها، تتمثل خيوط الاحتفالية المبهجة في مشاهد الفنون وحضورها الآسر والجميل مما يتمثل في حضور: الموسيقى والرسم والفنون والسينما والأغاني والمسرح ونحو ذلك مما كررت الرواية استدعاءه في عدد من فصولها، ولم تكتف بعموم الصورة وإنما دخلت في التفاصيل واقتبست فقرات ونماذج من تلك المادة الحيوية، كاشفة عن جانب من ثقافة الراوي والشخصيات، ومن ورائهم المؤلف للتنبيه إلى أهمية هذا العالم الفني الثري الذي يدل على حب الإنسان للحياة ولقيمها المبهجة الحية، وما تعلقه بالفنون وإنتاجه لها -حتى لو كان كفيفا- إلا علامة من علاماتها الحيوية الواعدة.
وثمة سبيل آخر يمكن عدّه من ألوان الكرنفالية والاحتفالية يتمثل في عدد من الرحلات خارج بيئة الاستبداد المتمثلة في البلدان الثلاثة الرمزية، كما في رحلة مولود إلى اليونان بحثا عن أخيه، وتعرفه من خلاله على أجواء الفنانات والتصوير السينمائي والأحاديث الفنية والثقافية التي تخللت الرحلة، وكذلك الحال رحلة مليكة إلى فرنسا، ورحلة فرقة المكفوفين إلى فرنسا أيضا وأقامة نشاط غنائي فني في باريس، ويمكن ان نضيف رحلة نجم الدين الصمدي إلى اليمن فرغم مشقتها جاء سردها مختلطا بالطرافة والسخرية، فهذه الرحلات سمحت بشيء من الحرية للشخصيات على تنوعها وأسباب رحلاتها، كما حرصت بذلك على الخروج النسبي عن قتامة أجواء جغرافيا الاستبداد لصالح المواقف الاحتفالية والمبهجة والساخرة التي أسهمت في تلطيف مناخات الرواية وتخفيف قتامتها.

الأحلام والكوابيس والعنف اللغوي
تقتضي الواقعية السحرية حركة أو تجوالا حرا أو ممكنا بين مكونات الواقع المعيش وصورته الكابوسية والحلمية، ولذلك كثيرا ما استعان الروائي بإمكانات هذا العالم، إما كمرآة تستعيد فيها الشخصية مواقف سابقة عاشتها وما زالت مؤثرة فيها، وإما ما تتطلبه المراجعة والتسوية لاستئناف الحركة إلى الأمام، ويكون الكابوس سبيلا للتجاوز أو المواجهة أملا في الوصول إلى مخرج أو طريق بعد انسداد الآفاق. كذلك فإن واقعا مرعبا كالذي صورته الرواية لا بد أن ينتج كابوسا لا يخلو من الرعب هو الآخر، فيلاحق الشخصيات، مثلما طاردت صورة القنفذ ذي الأشواك شخصية مولود، منذ وجه له ذلك الكائن أحد سهامه في طفولته الأولى. وظل يطارده في مناماته بالرغم من تعدد موارد الرعب في تجربته حتى غدا هو الآخر متسببا فيه للآخرين ومنتجا له بعد أن كان مستهلكا أول الأمر.
تطارد الكوابيس والأحلام كثيرا من الشخصيات في المنامات، مثلما تحضر في مواقف أقرب إلى أحلام اليقظة، وتكشف فيما تكشف عن البطانة النفسية للشخصيات وعن درجات من عمقها وأغوارها. وهي مادة صالحة للبحث والتحليل لمن يريد الإطالة في تحليل هذه الرواية المتفوقة، ويمكن أن نربط هذه المادة بمواقف السرد بضمير المخاطب، فهي تقريبا متممة لها أو متداخلة معها أحيانا، فهي إحدى آليات إنتاج الشفافية الداخلية والبطانة النفسية للشخصيات الآيلة للتمزّق والسقوط.
وأما العنف اللغوي فكثيرا ما يحضر في تلك الكوابيس وينتهي بالصحو المفزوع، لأنه يكشف فيما يكشف عن البطانة المرعوبة والأذى النفسي وقد يمثل ضربا من حساب الضمير وتصفية الحساب الداخلي. وقد جسدت الرواية جانبا آخر من العنف اللغوي خارج الكوابيس في مواقف كثيرة، منها مواقف الحوار الأمني أو مواقف التحقيق في أقبية المخابرات، وهذا التمثيل العنيف للغة هذه القطاعات يجد ضالته في ما يعرف بظاهرة العنف اللغوي الذي يصلح لتمثيل عنف الواقع وشخصياته ومواقفه، فلا يمكن لضباط التحقيق إلا أن يلجؤوا للغة العنيفة، اللغة التي تزري بالضحية وتضعها في دائرة الخطر سواء اُستعملت السخرية أو لغة الشتائم والتهديد والترويع اللفظي الذي يعدّ تمهيدا أو امتدادا لعنفهم المادي.

الأنواع المتخللة أو انفتاح الرواية
تتميز الرواية كجنس أدبي بانفتاحها على الأجناس والأنواع الأدبية وغير الأدبية، وبمقدرتها على هضم مكونات عديدة في نسيجها القابل للتحوير والانفتاح، وآية ذلك في (تاريخ العيون المطفأة) ما جاء فيها من توظيف لمادة الرسائل، في أكثر من فصل، خصوصا رسائل آسيا ومليكة إلى مولود، وإدماج هذه الرسائل ومحتواها الافتراضي في نسيج الرواية، وإلى جانب ذلك الإفادة في بعض الفصول من أنواع أخرى كالتقرير الصحفي أو المقالة الصحفية الإخبارية التي تسمح بتلخيص آخر للموضوع وتضمين الرواية وجهة نظر أخرى غير وجهة نظر الراوي الاعتيادي، إلى جانب اليوميات، ومقاطع الشعر والأغاني والأمثال والأقوال الشائعة ونحو ذلك من مواد متنوعة، تجعل من الرواية نسيجا متعدّد المكونات، ومع ميل الرواية إلى نسيج اللغة الفصحى فإن هذه المكونات المستضافة التي يجري تمثيلها تغدو نافذة مهمة تسمح بإظهار سمة التعدد اللغوي، بالرغم من وحدة النسيج العام واللغة الفصحى التي تتسيد هذا النسيج على المستوى التركيبي والصياغي.
ويجدر التنبيه إلى أن (تاريخ العيون المطفأة) ليست أهجية للعمى الاعتيادي أو القدري، بمقدار ما هي دفاع عن تلك العيون ومناشدة لها كي تتفتح وتنجو، ولقد اتسعت لجماليات كثيرة ومواقف مضيئة يمكن للمكفوفين أن يشاركوا فيها، بما فيها تصوير فرقة فنية متميزة كل أعضائها من المكفوفين نظمت احتفالا عالميا احتفاء بذكرى (برايل) صاحب البصمات المعروفة في عالم المكفوفين، وقدمت الرواية شخصيات شديدة التبصر والوعي كشخصية لطيف الكفيف الرسام والحقوقي المدافع عن حقوق الإنسان.
وفي مقابل الاحتفاء بالمكفوفين الأسوياء بالمعنى الحضاري، والتذكير في ثناياها بأبي العلاء المعري وطه حسين، فقد استعملت كناية العمى وضعف الإبصار للتعبير عن التشويش وعمّا يصيب الرؤية من انحراف وانشقاق وضعف، خصوصا مع تشعب عناصر الصراع واشتداده، فقدمت شخصيات فقدت بصرها وبصيرتها مثل الكولونيل رائد دوكان والد آسيا، ومثل شيماء في قمورين صاحبة المؤسسات المهتمة بالمكفوفين وذات العلاقات الوثيقة مع رئيسة قمورين التي أصيبت هي الأخرى بفقد البصر. وفي كل حال يُحمل هذا النوع من العمى على المعنى المجازي المختلف عن عمى المكفوفين من الصنف الأول صاحب البصيرة والمواقف الشجاعة.
إنها رواية تجسد أطرافا مؤلمة من الواقع العربي في سوريا وفي مختلف البقاع العربية، مثلت جوانب قاسية من العمى الحضاري، ومن فقد علامات الطريق، وامتلأت بالرغم منها بمشاهد العنف والقتل والتصفيات واختفاء الأبرياء، وبصور من الملاحقة الأمنية والدولة البوليسية التي لا تترك مساحة من الحرية لأحد، فإما أن تكون معنا أو ضدنا. وبذلك تدفع الفرد إلى التمزّق وإلى التشوش، وتتحوّل من راعية لمصالح شعبها إلى معطلة له ومدمرة لقدراته، ولكل ذلك فإن مثل هذا النظام حين سقط، بعد سنين قلائل من تمثيل هذه الرواية لبنيته وطبيعته وأدواته وجرائمه، جاء سقوطه مريعا لم يأسف عليه أحد ولم يدافع عنه أحد، بالرغم من غموض النظام البديل وعدم وضوح اتجاهاته وخياراته بعد.





























