بحسب تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء 2025، شهد مفهوم الحماية الدولية تحولا نوعيا مع إدماج التكنولوجيا الرقمية في إجراءات اللجوء.
فمع تصاعد الحروب والنزاعات، وتفاقم الأزمات الاقتصادية والبيئية، لم يعد تقديم طلب اللجوء، في بعض الدول الأوروبية، مشروطًا بالوجود داخل أراضي الدول المستقبلة، بل أصبح ممكنا عبر منصات إلكترونية تتيح لطالبي الحماية رفع ملفاتهم من بلدانهم الأصلية أو من دول العبور.
ويطرح هذا التحول أسئلة جوهرية حول العدالة والشفافية، ومدى قدرة الأنظمة الرقمية على حماية الفئات الأكثر هشاشة من مخاطر التمييز والإقصاء.
لجوء بلا حدود
منذ عام 2024، بدأت بعض دول الاتحاد الأوروبي الامتثال للميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، الذي دخل حيز التنفيذ في 11 يونيو/حزيران 2024 على أن يمتد التنفيذ العملي عبر فترة انتقالية حتى منتصف 2026، في تطوير نموذج يُعرف بـ”اللجوء بلا حدود”، وهو ما يتيح لطالب الحماية تقديم ملفه بالكامل عبر الإنترنت من بلده الأصلي أو من دولة ثالثة، من دون الحاجة للوجود داخل الدولة المستقبلة.
ويمثل هذا النموذج تحولا كبيرا في طريقة الوصول إلى الحماية الدولية، إذ يمكن للمتقدمين تقديم طلباتهم ومعرفة فرص قبولها قبل الانتقال جسديا إلى الدولة المستقبلة، وهو ما يقلل من المخاطر المرتبطة بالرحلات الخطرة والهجرة غير النظامية.
ويستهدف هذا النظام فئات محددة من الأشخاص الأكثر ضعفا، مثل ضحايا النزاعات المسلحة والكوارث البيئية، الذين غالبا ما يكونون عرضة لمخاطر كبيرة عند محاولتهم الوصول إلى الحدود الأوروبية.
بحسب تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية، نُشر في 11 يونيو/حزيران 2025، يُقيّم التقدم في تنفيذ “الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء”، فقد شرعت بعض الدول الأعضاء، من بينها بلجيكا وألمانيا، في تطوير أنظمة رقمية ومنصات إلكترونية مؤمّنة، تهدف إلى رقمنة إجراءات اللجوء بشكل متدرّج، بحيث تشمل مستقبلاً تقديم المستندات والمراسلات ومتابعة الطلبات عبر الإنترنت بشكل كامل.
ويؤكد التقرير أن الهدف الأساسي من هذه المبادرة هو منح المتقدمين فرصة معرفة مدى جدية طلباتهم وفرص قبولها، ومن شأن ذلك أن يقلل من الضغط على مراكز الاستقبال الحدودية، ويسمح للسلطات الأوروبية بفرز الطلبات بشكل أكثر فعالية، مع تقليل حالات الانتظار الطويلة والتكدس عند نقاط الدخول.
ويتطلب هذا النموذج تعديل التشريعات الوطنية في الدول الأعضاء لضمان الاعتراف القانوني بالطلبات المقدمة من الخارج عبر الإنترنت، بحيث تتمتع هذه الطلبات بالقوة القانونية نفسها التي تحظى بها الطلبات المقدمة من داخل الدولة.
وقد قررت بعض الدول، منح هذه الطلبات قوة إلزامية، بينما تُبقي دول أخرى هذا الإجراء مسارا استثنائيا.
كذلك يوضح التقرير أن التحديات التي تواجه هذا النظام لا تقتصر على الجانب القانوني، بل تشمل أيضا حماية البيانات الشخصية للمتقدمين وضمان وصول الفئات المستحقة إلى هذه الخدمات، خاصة في المناطق التي تعاني ضعف البنية التحتية الرقمية أو صعوبة الاتصال بالإنترنت.
ويضيف أن هذه الإجراءات تحمل أبعادا سياسية ودبلوماسية، إذ تمنح الدول قدرة أكبر على التحكم في من يمكنه التقديم إلكترونيا من الخارج عبر الاتفاقيات الثنائية مع المنظمات الإنسانية أو دول العبور.
تحيز الأنظمة الرقمية
يرى التقرير أن هذه السيطرة يجب أن تكون مصحوبة بشفافية واضحة في تحديد المعايير، لتجنب الاستغلال أو التمييز على أساس جنسي أو عرقي أو سياسي.
ومن الناحية العملية، يتطلب التعامل مع الطلبات عن بُعد اعتماد أدوات متقدمة للتحقق من هوية المتقدمين ومصداقية المعلومات المقدمة، مثل المقابلات المرئية المشفرة أو التحقق البيومتري عبر الهاتف، مما يساعد على تقليل الاحتيال، لكنه يثير أيضا تساؤلات حول تحيز الأنظمة الرقمية وقدرتها على حماية الحقوق الأساسية.
كما يشير التقرير إلى البعد الإنساني لهذا النموذج، إذ إن إتاحة التقديم الإلكتروني قد تزيد فرص الوصول إلى الحماية للفئات الضعيفة، لكنها في المقابل قد تستبعد فئات أخرى تعاني من ضعف الوصول إلى الإنترنت أو انعدامه نتيجة غياب البنية التحتية الرقمية أو الموارد التقنية.
ولذلك، يوصي التقرير بضرورة مراعاة هذه النقطة بوصفها عقبة يجب التغلب عليها مستقبلا، محذرا من أن يتحول هذا النظام إلى أداة فرز وانتقاء إذا لم تُراعَ الضمانات القانونية والشفافية في التنفيذ.
ودعا إلى مراقبة تأثير هذه السياسات وتقييم نتائجها بشكل دوري لضمان حماية حقوق المتقدمين واستدامة العملية من جهة، والتكيف المستمر مع التحديات التقنية والسياسية والاجتماعية التي تفرضها الهجرة الرقمية في القرن الـ21 من جهة أخرى.
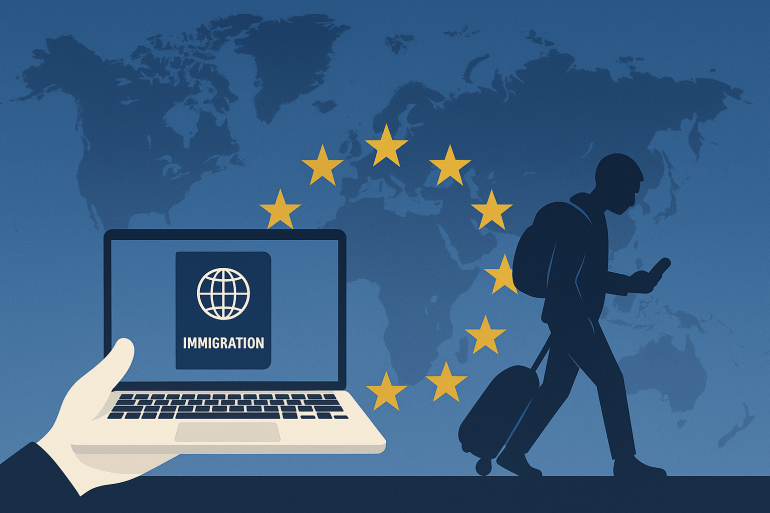
ثغرات وفجوات
رغم بساطة نظام اللجوء الرقمي الظاهرية، فإن ذلك لا يعني أن تقديم طلب الحماية عبر الإنترنت هو عملية سهلة أو تلقائية. فحسب التقرير الصادر عن وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء عام 2024، فإن كل طلب يخضع لإجراءات دقيقة تشمل تقييم الخلفية الأمنية والاجتماعية للمتقدم، والتحقق من صحة الوثائق، ومقابلات إلكترونية لضمان مصداقية المعلومات.
إحدى أهم العقبات الكبرى التي يواجهها اللجوء الرقمي هي الفجوة التقنية بين الدول الأوروبية وبلدان طالبي الحماية، فبينما تتمتع أوروبا ببنية تحتية رقمية متطورة لمعالجة آلاف الطلبات بكفاءة، قد يفتقر المتقدمون في مناطق النزاع إلى اتصال ثابت بالإنترنت أو أجهزة مناسبة أو معرفة تقنية كافية للتعامل مع المنصات الإلكترونية.
ويؤكد التقرير أن هذا الأمر يطرح تحديا كبيرا أمام فعالية النظام، ويستدعي توفير دعم تقني أو بدائل للوصول إلى الإنترنت لضمان عدم استبعاد المستحقين.
إضافة إلى ذلك، لا يقتصر التحدي على الجانب التقني فقط، بل يشمل البعد القانوني والإجرائي، فالدول الأوروبية مطالبة بالاعتراف القانوني بالطلبات المقدمة رقميا، وضمان أن يتمتع المتقدم بالحقوق نفسها التي يمنحها القانون للطلبات التقليدية.
ويسلط اللجوء الرقمي الضوء على حماية البيانات والخصوصية، فالمعلومات الحساسة التي يقدمها المتقدمون يجب أن تخزَن وتعالَج وفق معايير الاتحاد الأوروبي، مع التشفير والمراقبة المستمرة لمنع أي تسريب.
ويشير التقرير إلى أن إدارة هذه البيانات بعناية تعزز الثقة بالنظام وتشجع مزيدا من الأشخاص على التقدم بطرق قانونية وآمنة، كما تساعد السلطات على تحليل التدفقات وتخطيط الموارد بشكل أفضل.
وتمثل الفجوة المعرفية -حسب التقرير- تحديا جوهريا في تجربة اللجوء الرقمي، إذ يوجد عديد من الأشخاص الذين يمتلكون إمكانية الوصول إلى الإنترنت، لكنهم يفتقرون إلى المهارات التقنية اللازمة لتقديم طلباتهم بشكل صحيح، وهؤلاء المتقدمون مستحقون للحماية، بيد أن جهلهم بالتعامل مع الإنترنت، أو عدم فهمهم الخطوات المطلوبة، قد يحول دون وصولهم إلى الإجراءات القانونية اللازمة.
وقد تجعل هذه الفجوة بعض الأفراد الأكثر ضعفا ضحايا للبيروقراطية الرقمية، حيث يواجهون صعوبات في إرفاق المستندات أو تعبئة النماذج بالشكل الصحيح، مما يؤدي أحيانا إلى رفض طلباتهم أو تأخير البت فيها، وفقا للتقرير.
ويؤكد أن معالجة هذه الإشكالية تتطلب كثيرا من التوجيه والإرشاد من خلال إنشاء واجهة بسيطة بالخطوات الأساسية، لضمان ألا يتحول اللجوء الرقمي إلى وسيلة حرمان غير مقصود للمتقدمين الأكثر حاجة، وأن يبقى حق الوصول إلى الحماية متاحا لجميع المستحقين بغض النظر عن مستوى معرفتهم بالتقنية، وحتى لا يبقى اللجوء الرقمي مجرد أداة لتقديم الطلبات.

فرنسا كنموذج للهجرة الرقمية
تُعتبر تجربة فرنسا في مجال الهجرة الرقمية من أبرز المبادرات الأوروبية التي دمجت التكنولوجيا في مسار اللجوء بغية تسهيل تقديم الطلبات من خارج الأراضي الفرنسية.
ووفقا لتقرير صادر عن المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية في ديسمبر/كانون الأول 2024، فإن الحكومة الفرنسية بدأت منذ عام 2023 في تطوير منصة إلكترونية لتلقي الطلبات المبدئية عبر الإنترنت، ضمن سياسة تهدف إلى تنظيم الهجرة وتعزيز المسارات القانونية وتقليل المخاطر المرتبطة بالهجرة غير النظامية.
ويشير التقرير إلى أن المنصة الإلكترونية الفرنسية توفر للأفراد إمكانية تقديم طلباتهم كاملة، بما في ذلك الوثائق والمستندات الداعمة، مع التحقق من الهوية عن بعد باستخدام تقنيات متقدمة مثل التحقق البيومتري والمقابلات المرئية المشفرة.
واستهدفت المنصة في مرحلتها التجريبية الفئات الأكثر عرضة للخطر، مثل الصحفيين والناشطين السياسيين والعائلات في مناطق النزاع.

من الناحية القانونية، استندت التجربة الفرنسية إلى تعديل قانون دخول وإقامة الأجانب وحق اللجوء الذي أقره البرلمان الفرنسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2023. ونصت هذه التعديلات على منح الطلبات المقدمة إلكترونيا قوة قانونية.
غير أن هذه التجربة لم تخل من تحديات تقنية وأمنية، فقد أورد تقرير لصحيفة ليبراسيون، في مايو/أيار 2024، أن المنصة واجهت في الأشهر الأولى محاولات اختراق وهجمات إلكترونية، مما دفع السلطات إلى تعزيز إجراءات التشفير والبنية الأمنية بالتعاون مع الوكالة الوطنية لأمن نظم المعلومات.
ورغم ميزة الدمج بين التكنولوجيا والإجراءات القانونية، فإن النتيجة تبقى مرتبطة بالتحقق الأمني والصحي عند وصول المتقدمين إلى الأراضي الفرنسية. فالموافقة المبدئية لا تعني القبول النهائي، بل تمنح فرصة تنظيمية لمتابعة الحالات الأكثر احتياجا، مع احترام الضوابط الوطنية والأوروبية.
ويبقى هذا المسار عرضة لتأثيرات السياسة، وصعوبات البنية التقنية، والقيود القانونية، مما يجعل استمراره ونجاحه مرتبطين بقدرة فرنسا على إيجاد توازن محسوب بين الانفتاح على طالبي الحماية وتشديد الرقابة، وبين الأبعاد الإنسانية ومتطلبات الأمن.


